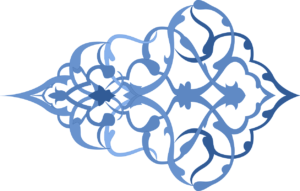معنى التغابن والتحذير من الغبن
فنحن في تفسير آياتٍ من سورة التغابن، وكما سبق معكم في تفسير معنى كلمة التغابن، فإنّ الغَبْن هو فِعْلُ الإنسان إذا اشترى شيئًا بأكثر من قيمته وهو غير معتادٍ تحمُّل ذلك الغَبْن، أو باع شيئًا بأقلَّ من قيمته بشكلٍ فاضحٍ، فهذا يُقال له: المغبون في أمور دنياه.
والقرآن ذكر المغبون في أمر دينه وإسلامه ومستقبله الدنيوي ومستقبله الأبدي، ليحذَرَ المسلمُ من أن يكون مغبونًا في إسلامه وفي دينه وفي قرآنه، بأن يبيع باقيًا بفانٍ، وأن يبيع خالدًا بزائل، وأن يبيع دينه بدنياه.
وهذه السورة من العلم الذي يجب على كل مسلمٍ أن يَعْلَمه ويعلِّمه، لئلا يكون المسلم مغبونًا خاسرًا في دنياه وفي آخرته، لأنَّ الإسلام أتى ليحقِّق للإنسان سعادته لا في عالم الآخرة والسماء فحسب، إنما الإسلام كما علمنا الله عزَّ وجلَّ في كتابه الكريم: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة:201].
ولقد كرَّم الله عزَّ وجلَّ العرب بالإسلام، فبعد أن كانوا جهلاء صاروا علماء وحكماء، وبعد أن كانوا فقراء صاروا ملوكًا وأغنياء وأثرياء، وبعد أن كانوا مستعمَرِين يعيشون مع الوحوش في الصحراء صاروا محرِّرِين لشعوب العالَم، ونقلوا شعوب العالَم من الظلم والجور إلى العدل، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الاضطهاد والاستبداد إلى الحرية، ومن التباعد والتمزُّق إلى المحبة والأخوة.
فلما بَعُد المسلمون عن الإسلام بَعُدوا عن سعادتهم وعن وحدتهم وعن العلم، وبَعْد أن كانوا قادة العالَم يقودونهم إلى السعادة والعلم والحكمة ومكارم الأخلاق صاروا بشكلٍ يحتاجون فيه إلى أن يرحمهم أعداؤهم.. فلا بدَّ من العودة إلى القرآن لا تلاوةً بلا فهمٍ، ولا قراءةً بلا علم: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص:29].
فيجب على المسلم والمسلمة أن يترسَّخ في نفوسهما عنوان هذه السورة حتى لا يكون المسلم والمسلمة مغبونَين في أي شيءٍ من أمورهما، خاصةً في دينهما وفي أخلاقهما.
وكان السلف الصالح إذا عمل أحدهم حسنةً وضع حصاةً في جيبه الأيمن، وإذا عمل سيئةً وضع حصاةً في جيبه الأيسر، فإذا أمسى المساء قارن بين الحصى اليمين واليسار، فإذا زادت حَصَيَات جيبه الأيمن يقول: الحمد لله لستُ مغبونًا، وإذا زادت حَصَيات السيئات كان يستغفر ويستدرك بأعمالٍ صالحة، ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود:114].
فإذا أراد المسلم أن يبيع أو يشتري أو يجتمع مع أشخاص أو يَمْضِي عليه أي وقتٍ من الأوقات فَلْيتذكَّر سورة التغابن، ولْيحذر من أن يكون مغبونًا في دِينه أو في سهرته أو مع رفيقه أو في سفره أو في ماله، يقول عليه الصلاة والسلام: ((الدُّنيا مِضمارٌ، وَالآخِرةُ سِباقٌ، وَالغايةُ الجَنَّةُ أَو النَّارُ)) .
الإيمان الصادق والعمل الصالح ميزان الربح والخسارة
ثم مضى معكم في نفس السورة قوله تعالى عن الذين فقهوا القرآن.. وقد قال ﷺ: ((مَن يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيرًا يُفقِّهْهُ في الدِّينِ)) .. وأعظم الفقه ورأس الفقه ومصدر الفقه كتاب الله عزَّ وجلَّ المشروح بسنة رسول الله ﷺ، فذَكَر الله عزَّ وجلَّ الرابحين والفائزين المفلحين فقال: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ [التغابن:9] في ذلك اليوم يظهر الرابح من المغبون، والرابح من الخاسر، قال: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِالله﴾ [التغابن:9] الإيمان: ((أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ)) ، الإيمان: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر:28] الإيمان الذي يدفعك إلى أداء فرائض الله، والوقوف عند حدود الله عزَّ وجلَّ، والترفُّع عن الدنايا والرذائل.
﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِالله﴾ [التغابن:9] فإذا وُجِدَ الإيمان بمعناه الحقيقي الذي وقر في القلب فلا يتخلَّف عنه أن يصدِّقه العمل، وأمَّا إذا ادَّعى الإنسان الإيمان ولم يُوجَد العمل فإيمانه غرورٌ وأوهامٌ وأمانٍ، ((لَيْسَ الإِيمَانُ بِالتَّمَنِّي وَلا بِالتَّحَلِّي، وَلَكِنْ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ)) .
ولذلك دائمًا إذا ذَكر الله عزَّ وجلَّ الإيمان في القرآن يَذكر ظلَّه وهو العمل الصالح: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا﴾ [التغابن:9] يعمل صالحًا بيده، وبلسانه فلا يتكلم إلا الكلام الطيب، وبعينه فلا ينظر إلا إلى ما أحلَّ الله عزَّ وجلَّ، وبأذنه فلا يستمع إلا إلى ما أباح الله عزَّ وجلَّ له وأوجب الله عليه، ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ﴾ [الإسراء:36] كل ما في نفسك.. فإذا كان فيها حقد أو غِشٌّ أو مكر فأنت مغبون بقاموس الله عزَّ وجلَّ وبقاموس القرآن وبقاموس الإسلام، ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء:36].
﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ﴾ إذا أردتَ أن تتكلَّم أيَّ كلامٍ في بيعك أو في شرائك، أو في سَمَرك مع صديقك، فاعلم أنَّ كلامك مسجَّل بكلماته وحروفه، ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق:18] فلتكن في كلامك رابحًا لا خاسرًا ولا مغبونًا.
شياطين الإنس والجنِّ مهمتهم غبن المسلم
لا تنسَ سورة التغابن، الشيطان يريد أن يجعلك مغبونًا وخاسرًا، وشرُّ الشياطين شياطين الإنس، سُئِلَ النبي عليه الصلاة والسلام لَمَّا أنزل الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ [الأنعام:112]، قَالوا: يَا رسول اللهِ وَهَلْ لِلإِنْسِ شَيَاطِين؟ قَالَ: ((نَعَمْ، وهُم شَرٌّ مِن شَيَاطِينِ الجِنِّ)) ، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6)﴾ [الناس:1-6] من شياطين الجن ومن شياطين الناس، وقد يكون أخوك شيطانًا، لأن الشيطان ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ﴾ [البقرة:205].
فمن يدعوك إلى معصية، أو يثبِّطك عن طاعة، أو يأمرك بمنكر، أو ينهاك عن معروف، أو يحول بينك وبين واجب أو يغريك بمعصية، هو شيطان، وقد يكون أخاك، وقد يكون أباك، وقد تكون زوجتك، ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ [التغابن:14] “إن مِن”: يعني إنَّ بعضهم لا كلهم.
جزاء المؤمن الصالح الرابح
﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِالله﴾ الإيمان الذي يحجزه عن محارم الله عزَّ وجلَّ، ويسارع به إلى مرضاة الله عزَّ وجلَّ، ﴿وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ﴾ [التغابن:9] لأنَّ ﴿ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود:114]، ﴿وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ﴾ ليس جنة ولا جنتين بل جنات، ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا﴾ من تحت قصورها ﴿الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾، خلودٌ بلا موت، وأبدٌ بلا زوالٍ ولا فناء، فهل هؤلاء مغبونون أم رابحون؟ قال: ﴿ذَلِكَ﴾ أي مغفرة السيئات ودخول الجنات مع أبد الآبدين هو ﴿الْفَوْزُ﴾ والنجاح والربح ﴿الْعَظِيمُ (9)﴾ فإذًا هذا ليس مغبونًا وهؤلاء ليسوا بمغبونين، فمن المغبونون؟ قال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [التغابن:9-10].
الكفر قسمان
والكفر على قسمين: كفرٌ كليٌّ عامٌّ بأن يرفض كل ما أنزله الله عزَّ وجلَّ من وحيٍ على أنبيائه ورسله، وأن يرفض كل ما أنزله الله عزَّ وجلَّ على سيدنا محمدٍ ﷺ من القرآن وما بلَّغه النبي عليه الصلاة والسلام من تعاليم، هذا الكفر الكليُّ العامُّ.
وهنالك كفرٌ جزئيٌّ خاصٌّ، كمن يترك الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: ((مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ)) ، كفر بوجوبها وكفر بأدائها.. ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ﴾ [آل عمران:97] يعني من لم يحج وهو يستطيع، فسمَّاه الله عزَّ وجلَّ كافرًا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن النساء: ((إنَّهُنَّ يَكْفُرْنَ))، قالوا: أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ يا رسول الله؟ قال: ((لا، يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ)) ، وبالطبع ليس كلهن، ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ الله﴾ [النساء:34].. إلخ.
جزاء الكافر الجاحد المغبون
﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ يرفضون القرآن جحودًا وإنكارًا وإلحادًا، قال: ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [التغابن:10] هل هؤلاء رابحون أم مغبونون؟ ومتى يظهر الغبن للإنسان؟ قال: يكون في دنياه لا يرى نفسه أنه الخاسر وأنه المخذول وأنه الشقي التعيس، لكن متى يظهر؟ قال يظهر: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ﴾ يوم القيامة ﴿ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ [التغابن:9] ذلك اليوم يعرف الإنسان نفسه إن كان رابحًا أو مغبوبًا خاسرًا.
شرط الدعاء العمل
نسأل الله أن لا يجعلنا من المغبونين في ديننا ولا في دنيانا.. وهذا دعاء، والدعاء وحده لا يكفي، بل لا بدَّ مع الدعاء والطلب من الله عزَّ وجلَّ من عمل، فإذا أراد الإنسان أن يكون له الولد فلا بدَّ له من أن يعزم ويعمل الأسباب على أن يتزوَّج ليتحقَّق طلبه ودعاؤه لله عزَّ وجلَّ، فلا حصاد بلا زرع، ولا أولاد بلا زواج، ولا نصر بلا جهاد.
وكما ينصُّ القرآن العظيم: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ ثم قال تعالى: ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي﴾ [البقرة:186] الله تعالى يقول: كذلك أنا، فكما يدعونني لأستجيب لهم كذلك أنا أدعوهم، فليستجيبوا لي حتى أستجيب لهم، ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ [البقرة:40]، ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [الشورى:38]، ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة:152] أما الدعاء وحده فكما ورد عن أعرابيٍّ قال لعمر رضي الله عنه: لقد أصاب جمالي الجَرَب، فادع الله لي أن يشفيها، فقال: أنا سأدعو لك، ولكن اجعل مع الدعاء قطرانًا ، استعمل مع الدعاء الدواء الذي خلقه الله عزَّ وجلَّ للشفاء.
اكتشاف الغبن والربح يوم القيامة
فالذين كفروا هؤلاء مغبونون، وقد لا يَظهر غبنهم في حياتهم الدنيا، فيرى نفسه في الدنيا أنه الرابح وأنه المغبوط وأنه المحسود وأنه وأنه.. ولكن ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ﴾ عند الموت تتبيَّن الحقائق، ﴿فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيد﴾ [ق:22]، عند ذلك يرى غَبْنه وخسارته ويعلم أنه خسر العمر والحياة والإيمان فيقول: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾ [المؤمنون:99-100] الغني يقول: أرجعْني إلى الدنيا لأُخرجَ الزكاة، وأرجعْني إلى الدنيا لأُؤدِّي فرائضك من صلاةٍ وصوم، ولأَستسمح من غرمائي والذين اعتديتُ عليهم ليسامحوني، ﴿قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾ تركتُ الجاه والمال وأمورًا كثيرة كنتُ أستطيع أن أعمل فيها وبها الأعمال الصالحة.. ﴿كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ﴾ [المؤمنون:99-100] سَدٌّ فلا يرجع إلى الدنيا، هل يستطيع المولود أن يرجع إلى بطن أمه؟ وكذلك الإنسان إذا خرج من جسده ينتقل إلى عالَمه الجديد.
وهناك يظهر الفائز الرابح مِن المغبون الخاسر، ولا سيما أن الإيمان والعمل الصالح لا يُفقدك دنياك، بل إن الإيمان والعمل الصالح يرفع شأنك ويُعزُّك ويُكرِمك: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون:8] ولكنه ليس إيمان القول، ولا إيمان اللسان، ولا إيمان الأماني، بل إيمان العلم والعمل والحكمة وتزكية النفس ومجاهدتها.
﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [التغابن:10] ولو كان في الدنيا إمبراطورًا ومليارديرًا، وعاش مئة سنة بصحة وشبابِ الثلاثين سنة، وبعد ذلك نهايته: ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [التغابن:10] فهل ربح مِن شبابه ومِن غناه ومِن دولته ومِن ملكه ومِن جماله؟ ﴿أُولَئِكَ﴾ مَن يقول هذا القول؟ هذا ليس فيه استئناف، [الاستئناف محكمة تعيد التحقيق في القضية والحُكم]، وليس فيه خطأ حتى يُصحَّح، هذا الكلام يقوله ربُّ العزة خالق الكون، الذي خَلَقَنا من ذرَّةٍ لا تراها العيون، فجعل منَّا إنسانًا سويًّا، وجعل فلاناً محامياً وفلاناً دكتور وفلاناً وزيراً وفلاناً أميراً، ثم أرسل لنا أشرف ملائكته بأشرف رسالاته إلى أرضه بواسطة أشرف أنبيائه.
فإذا رَفَضْنا دراستها وتعلُّمها والعمل بها صرنا أصحاب النار وخالدين فيها وبئس المصير، وإذا كان المصير هكذا فـ﴿مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ (29)﴾، فتقول الملائكة: ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30)﴾ ضعوا له الأغلال في عنقه، ﴿ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31)﴾ أدخلوه في الجحيم، ﴿ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (32) إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِالله الْعَظِيمِ (33)﴾ إيمانًا يحجزه عن محارم الله، ويدفعه إلى أداء فرائض الله، ﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ [الحاقة:28-34] هل هذا رابح أم مغبون؟ فإذا بعتَ صفقةً ربحتَ فيها دنيويًّا فانظر هل ربحتَ فيها دينيًّا وإسلاميًّا؟ وإذا خاصمتَ إنسانًا وانتصرتَ عليه، فهل هذا النصر يوافق دين الله عزَّ وجلَّ؟ وهل انتصرتَ بعدلٍ وحقٍّ أم بظلمٍ وبغيٍ وعدوان؟ فإذا كان ببغيٍ وعدوان فأنت لستَ منصورًا، بل أنت مغبون.
وهكذا إذا غضبتَ أو إذا أحببتَ أو إذا عاديتَ أو إذا أعطيتَ أو إذا منعتَ فاذكر عنوان سورة التغابن، هل شبابك الذي صُرِف في عمرك ربحتَ مقابِلَه ما هو أعزُّ منه وأغلى لتكون رابحًا؟ وإذا ذهب الشباب وأخذتَ مقابله سيئات وذنوبًا وسوادَ الوجه عند الله عزَّ وجلَّ فهل أنت رابح أم مغبون؟
وإذا صاحبتَ إنسانًا فدلَّك على الهدى والتقوى والقرب من الله عزَّ وجلَّ فهل أنت بهذه الصحبة رابح أم مغبون؟ والمرأة مع المرأة، والشاب مع الشاب.. فنسأل الله عزَّ وجلَّ أن يجعلنا رابحين في كل نَفَسٍ مِن أنفاسنا، في صحبتنا وفي مالنا وفي أعمالنا وفي رضانا وفي غضبنا وفي حبنا وفي عداواتنا، وأن نعادي من يعادي اللهَ ودينَه، وأن نُحِبَّ من يحبُّ اللهَ ومحبوباتِه من الأعمال والأخلاق.
الإيمان بالقضاء والقدر يحمي من جزع المصائب
ثم قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ بِالله يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [التغابن:11] قال: عندما يصاب الإنسان بمصيبة كفقد ماله أو أحبابه أو صحته حينها يَظهر إيمان المؤمن قوةً وضعفًا؛ يظهر قوة إيمانه أو ضعف إيمانه أو موت إيمانه، فعند المصيبة فإنّ الرابح الذي ليس بمغبون يستقبل المصيبة بإيمانه بقضاء الله وقدره، فيجعل الله عزَّ وجلَّ من هذه المصيبة مغفرةً لذنوبه، ورفعةً لدرجاته، وقربةً إلى ربه.
((لا يُشاكُ المؤمِنُ بشَوكةٍ إلَّا وَيُؤجَرُ عَلَيها)) ، فإذا استقبلها بالرضاء بقضاء الله وقدره، والتسليم لقدر الله عزَّ وجلَّ فهل هذا يكون رابحًا أم مغبونًا؟ رابحًا، ماذا ربح؟ أولًا ربح الثواب بالرضى بقضاء الله وقدره، والربح الثاني أنه لو تململ وتضايق وحزن وتكدَّر فهذا يؤثِّر على قلبه وشرايينه وأعصابه، وربما يوقعه في مرضٍ عضال، فقد يصاب بالفالج أو بداء السكر أو يموت فجأةً، وهذه الأمور هل هي ربح أم خسارة؟ هل هي ربح أم غَبْن؟
الإيمان بحكمة الله عزَّ وجلَّ
﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله﴾ [التغابن:11] يعني بإرادته ومشيئته وبما سبق به قضاؤه وقدره.. والقضاء والقدر يقع على حسب النظام الكوني في هذا الوجود، وكذلك بخطئك وبإخلالك في أمورك، وهناك شيء فوق الإرادة، والذي فوق الإرادة قد يكون حكمة إلهية لمصلحتك وأنت لا تعرفها، حتى يكشف الله عزَّ وجلَّ عنك الغطاء، ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [ق:22] كما وقع لسيدنا موسى والخضر عليهما السلام، لما مشى موسى مع الخضر -وهذا تعليمٌ قرآنيٌّ من الله عزَّ وجلَّ للإنسان، كيف يستقبل الأشياء التي يعجز العقل عن إدراك كُنْهها وحِكْمَتها- فركبا في السفينة، وأركبوهما مجَّانًا لوجه الله تعالى، فعمد سيدنا الخضر إلى أحد ألواحها فكسره، فقال له موسى عليه السلام: ﴿أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا (71)﴾ هذا شيء كبير فظيع، ماذا فعلت؟ ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف:71-72]، قال
وإذا كُنتَ بِالْمُدَرَكاتِ غِرًّا
ثُمَّ صَادَفتَ حاذِقًا لا تُمارِي
وإذا لم تَرَ الهِلالَ فَسَلِّمْ
لأُناسٍ رَأَوهُ بِالأَبصارِ
“وإذا كنتَ بالمدرَكات غِرًّا”: إذا كنتَ جاهلًا بالأشياء التي ينبغي أن تُدْرِكها.
وقد قال له الخضر عليه السلام من أول الطريق: ﴿فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [الكهف:70] وهذا من أدب المتعلِّم مع المعلم، فليس كل ما يدركه معلِّمك تستطيع أن تدركه، وهل يدرك المريض كل ما يدركه الطبيب في جسده؟ فإذا أعطاه المرَّ يجب أن يَقبَل، وإذا شقَّ له بطنه يجب أن يَقبَل، وربما يُخَدِّره ويُفْقِده سمعه وبصره وعقله وشعوره فعليه أن يَقبَل.
ثم رأوا غلامًا فقتله فقال له: ﴿أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾ [الكهف:74]، وبعد أن شرح سيدنا الخضر لسيدنا موسى عليهما السَّلام: ﴿قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ [الكهف:78] وإلى آخر الآيات.
الشاهد: ليس كل شيء من قضاء الله وقدره يستطيع الإنسان أن يعرف حكمته.
قصة الملياردير الذي قال: لو كنت أقرأ وأكتب لكنت زَبَّالاً
يقال: إنَّ شخصًا دخل على رجل ملياردير عنده ثروات وأعمال ومصانع وإدارات وكذا وكذا، وفي أثناء جلوسه عنده دخلت عليه معاملة مِن أجل أن يُوقِّعها، فأخرج خَتْمَه من جيبه وختم، فقال له: لم لا توقِّع باسمك؟ قال له: أنا أُمِّيٌّ لا أقرأ ولا أكتب، قال له: عجيب! كل هذه الثروة والمال والأعمال وأنت أُمِّيٌّ! فلو كنتَ عالِمًا قارئًا كاتبًا ماذا ستكون؟
قال له: لو كنتُ قارئًا وكاتبًا وعالِمًا لكنتُ زَبّالاً [عامل نظافة]، قال: ولِمَ تقول زَبّال؟ قال: نعم، زَبّال، قال: أنا لا أفهم عليك، فهل تتكلم جَادّاً؟، قال: نعم، ثم قال: لأنني كنتُ فقيرًا وأُمِّيًّا، وبسبب فقري ما استطاع أهلي أن يعلِّموني، فنُشِر إعلان لطلب زَبَّالين [عاملي نظافة] في البلدية، فذهبت مع الذاهبين، فلما طلبوا مني أن أوقِّع على قبول الوظيفة، قلت لهم: أنا أُمِّيٌّ لا أقرأ ولا أكتب، فقال الموظف: اطردوه، إذا كان لا يعرف القراءة والكتاب فهذا لا يصلح أن يعمل عندنا، قال: فطردوني.
فذهب إلى السوق، وفتح الله عليه.. قال له: فلو كنتُ أقرأ وأكتب لسجَّلوني زَبّالاً، وكان غاية ما سأصل إليه أن أصير رئيس الزَّبّالين [عمال النظافة].
والشاهد أنه بالنسبة لقضاء الله عزَّ وجلَّ قد يكون المظهر والمبدأ يُسيءُ ويُوجِعُ ويؤلِم، لكن يأتي الإسلام ويَدْفَع عنك بالإيمان هذه الصدمة، وهذا أوَّلًا، وثانياً يُزِيْل حزنَك ويقول لك: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق:1].
قال الخضر لسيدنا موسى عليهما السَّلام عن الغلام الذي قتله: هذا لو عاش سيكون سببًا لهلاك والديه، فأبدلهما الله عزَّ وجلَّ عنه ببنتٍ خرج من نسلها سبعون نبيًّا ، فما اختاره الله عزَّ وجلَّ أحسن مما اختاراه لنفسيهما، مع أنه لم تظهر لهما الحكمة.. وهنا الإيمان! ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ [البقر:3]، و((الْإِيمَانُ بالقضاءِ والْقَدَرِ يُذْهِبُ الْهَمَّ وَالْحَزَنَ)) .
ما مَجَاز الإيمان؟
أتى بعض الوفود إلى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فسألهم: ((مَا أَنْتُمْ؟)) قالوا: مُؤْمِنُونَ، قال: ((إنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةً، فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكُمْ؟)) قَالُوا: خَمْسَ عَشَرَة خَصْلَةٍ، خَمْسٌ أَمَرَتْنَا رُسُلُكَ أَنْ نَعْمَلَ بِهَا، وهي أركان الدين الخمسة: الشهادتان والصَّلاة والصَّوم والحج والزكاة، وخَمْسٌ مِنْهَا أَمَرَتْنَا رُسُلُكَ أَنْ نُؤْمِنَ بِهَا: أَنْ نُؤْمِنَ بِالله، وَمَلَائكتِه، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، واليوم الآخر.. والإيمان فيه شيءٌ عقائدي، وشيء أخلاقي وسلوكي، وهو ما يُسمَّى بمَجَاز الإيمان، مثلًا: ((لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّه لِنَفْسِهِ)) ، ((لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَأْمَنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ)) يعني غدره ومكره، وهذه الأخلاقيات والسلوكيات تُسمَّى مَجاز الإيمان.
قَالُوا: “وَخَمْسٌ تَخَلَّقْنَا عليها في الْجَاهِليَّةِ”.. وهذه من آثار الدين الإبراهيمي، لأنَّ العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام، فبقي بقية منه، واختلطت بأمور من البدع والجاهلية.. إلخ.
واجب شكر المنعم خصلة حميدة في الجاهلية والإسلام
قال لهم: ((مَا الْخَمْسُ؟)) قالوا: “الأولى الشُّكْرُ عِنْدَ الرَّخَاءِ”، فإذا أغناك الله عزَّ وجلَّ فهذا رخاء، وكذلك إذا رفعك الله عزَّ وجلَّ ورفع شأنك وأعزك وقوَّاك فصرتَ أميرًا أو وزيرًا، أو صرتَ غنيًّا.
“الشُّكْرُ عِنْدَ الرَّخَاءِ”، والشكر ما يجمع أوصافًا ثلاثة، وهي: أن تحمد وتمدح المنعِم الذي أوصل إليك النعمة، وأن تشكره بأعمالك ولا تكتفي بالكلمات الهوائية مثل: “أطال الله عمرك، أدامك الله لنا”، فانظر إلى ما تستطيع من عمل لتعمله مقابل ما أحسن إليك.
والشكر من المُنْعَم عليه هو ما جمع ثلاثة معانٍ، [واجب المُنْعَم عليه أن يقابل المنعِم بثلاثة أشياء]
• أن يحمده بلسانه ثناءً ومدحًا.
• وأن يحمده بأعماله وبخدمته له وأن يقابِل الحسنة بمثلها.
• وأن يُقابِله بحبه وتقديره القلبي.. وهذه المعاني الثلاث جمعها الشاعر بقوله:
أَفادَتْكُمُ النَّعماءُ مِنِّي ثَلاثةً
يَدِي وَلِسانِي وَالضَّمِيرَ الْمُحَجَّبا
“أفادتكم النعماء”: نعمتكم التي أنعمتم بها عليَّ، أفادتكم منِّي ثلاثة أشياء، “يَدِيْ”: كلها تسعى في المكافأة على المعروف والنعمة المسداة منكم إلي، “ولساني”: مدحًا وشكرًا وثناء، “وَالضَّمِيرَ الْمُحَجَّبا”.
فقالوا: “خَمْسُ خِصَالٍ” تخلَّقوا عليها من دين إبراهيم في الجاهلية، منها: “الشُّكْرُ عِنْدَ الرَّخَاءِ”، إذا أسدى لك أحدٌ معروفًا صرتَ مَدِينًا له، ويجب أن تكافئ المحسن بمثل إحسانه، أو بأزيد منه، فالشكر شعبةٌ من شعب الإيمان، ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء:86] إذا قال لك: “السلام عليكم” يجب عليك أن تُكافأه بتحيةٍ مثلها أو أحسن منها، فكيف إذا عمل معك شيئًا أكبر من التحية! كما إذا كنتَ مدينًا أو محتاجًا لقرضٍ فأقرضك، أو عاطلًا فهيَّأ لك عملاً، أو في ضيقٍ ففرَّج عنك، أو جاهلًا فعلَّمك، أو فاسقًا وتبتَ على يديه فتاب الله عزَّ وجلَّ عليك وأنقذك من الظلمات إلى النور؟
قالوا: “الشكر عند الرخاء” وكذلك الولد مع الوالد: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ [لقمان:14]، يذكرون عن الإمام الشافعي أنه كان في درسه وحوله المئات من العلماء، فمرَّ عليه غلامٌ أعرابيٌّ، يعني بدوي، وعندما رآه الإمام الشافعي قام له ودعاه إلى جنبه وأجلسه بجانبه.
فدهش العلماء وتلامذة الإمام الشافعي منه، لأنه قطع الدرس من أجل ابن رجل أعرابي بدويٍّ كما يظهر من هيئته وشكله، فقام له الشافعي ودعاه ليجلسه عن يمينه، فلما انتهى المجلس سألوه: لمَ فعلتَ هذا؟ وما الدافع لذلك؟ قال: إنَّ والد هذا الغلام الأعرابي علَّمني مسألة سألتُه عنها، وهي: متى يبلغ الكلب سن الزواج؟ فأجابني وعلمني أنَّ الكلب يبلغ بعد سنةٍ من عمره، قال: فشكرًا لِمَا علَّمني أبوه -هذه المسألة- قمتُ لولده وفاءً لوالده.
فأين إسلامنا؟ [وأين نحن!] وهل مذهبك شافعي أو حنفي أو جعفري أو مالكي أم أهوائي أناني جاهلي؟ نسأل الله عزَّ وجلَّ أن يتوب علينا، ويوقظنا من نوم الغفلة ومن سكرة الجهالة.
قيمة الصبر
قَالُوا: “الشُّكْرُ عِنْدَ الرَّخَاءِ، والصَّبْرُ عِنْدَ الْبَلَاءِ”، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ((الصَّبْرُ شَطْرُ الْإيمانِ)) ، الصبر أن تتحمَّل المكاره والشدائد برباطة جأشٍ وصمود نفسٍ، فلا تتزعزع أمام المصائب والكوارث، سواء كانت خسارة أو عدواناً أو شدة أو مرضاً أو آلاماً أو تسلُّطاً، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ((الصَّبْرُ شَطْرُ الْإيمانِ)).. هؤلاء في الجاهلية! وهؤلاء عبدة الأوثان! لكن بقي فيهم بقيةٌ من دين إبراهيم عليه السَّلام.
الرضا بقضاء الله من صفات أهل القرآن
قَالُوا: “والثالثة الرِّضَى بِمُرِّ الْقَضَاءِ”، كما إذا وقعَتْ عليك قضية، أو حُبِسَت الأمطار فجفَّ الزرع فيبس، وكل ما أنفقتَه كان عليك خسارة، أو غرقت بضاعتك في البحر، أو أُحرِقَ دكانك، أو مات لك عزيزٌ من أبٍ أو ابن أو أخٍ أو صديق، فهنا يَظهَرُ إيمانك بالقضاء والقدر.
ذكرتُ لكم فيما مضى قصة الأصمعي لَمَّا دخل على أحد قبائل العرب، ورأى حول القبيلة جِمالًا كلها ميتة من وباءٍ أصابها، فالتقى بصاحبها وهو على تلة وبيده مِغْزَل، فأراد أن يُعزِّيه بمصيبته التي أصابته، فردَّ عليه المُصابُ فاقدُ الثروةِ كلِّها قائلًا
لا وَالَّذي أَنا عَبدٌ مِنْ خَلائِقِه
وَالمرءُ في الدَّهرِ رِزءُ الهَمِّ والحَزَنِ
ما سَرَّني أنَّ إِبْلِي في مَبَارِكِها
وَما جَرَى مِن قَضاءِ اللهِ لَم يَكُنِ
بما أن الله عزَّ وجلَّ قضى هكذا فأنا مسرور بقضاء الله أكثر من سروري ببقاء ثروتي وجِمالي في مَبَارِكِها.. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر.. وكيف كان الإيمان بالقرآن؟ كان كل واحدٍ منهم مصحف العمل، يُقرَأ القرآن في أعمالهم وفي أخلاقهم وفي تقواهم وفي خشيتهم لله وفي سلوكهم، والآن مصحفنا ورق وحبر، فأين الورق والحبر من نفوسٍ مزكَّاةٍ، وأرواحٍ مقدَّسةٍ، وعقولٍ حكيمةٍ، وأعمال الأنبياء والمرسلين!
ولذلك فإن الله عزَّ وجلَّ جعلهم خير أمةٍ أُخرِجت للناس، وجعلهم سادة الدنيا، وجعلهم هيئة الأمم ومجلس الأمن.. وأين المسلمون الآن؟ أين المسلمون من القرآن؟ أين المسلمون من قرآنِ أعمالِ النبيِّ عليه الصلاة والسلام في أقواله وأعماله وحكمته؟
فعلى كلّ واحد منكم من كبيرٍ أو صغير، من ذكرٍ أو أنثى، أن يقوم ليبني إيمانه بتقوى الله عزَّ وجلَّ، وبأداء الفرائض والنوافل، وبكثرة ذكر الله، وبصحبة الصالحين، والبعد عن صحبة الفسَّاق والأشرار والفاسقين.
الإيمان هكذا يَرْبُو، وهكذا ينمو، وهكذا يُلوَّث، وهكذا يمرض، وهكذا يموت.. وعليكم أن تعلِّموا الناس بما تسمعون، وأن تعلِّموهم بما تعملون؛ بأخلاقكم وتقواكم وخشيتكم وأمانتكم واستقامتكم.. ومتى ما زرعنا وسقينا وسَمَّدنا سنحصد ونقطف، أما بلا بذارٍ ولا حرث ولا سقايةٍ ثم ندعو الله عزَّ وجلَّ أن نحصد
تَرجُو النَّجاةَ وَلَم تَسلُكْ مَسَالِكَها
إنَّ السَّفِينةَ لا تَجرِي عَلى اليَبَسِ
ترك الشماتة وحسن اللقاء
قَالُوا: “الشُّكْرُ عِنْدَ الرَّخَاءِ، والصَّبر عند البلاءِ، والرِّضَا بِمُرِّ الْقَضَاءِ، وَتَرْكُ الشَّمَاتَةِ بالأعْدَاءِ”، عدوُّك إذا وقع وكنتَ مؤمنًا فإمّا أن يكون أخاك المؤمن أو أخاك الإنسان، فيجب أن تأتي إليه وتجبر مصابه، وتساعده على ما هو بحاجةٍ إليه، وتُضَمِّد جراحه، وتعزِّيه بما فاته وما أصابه، هذا إذا كنتَ مؤمنًا، أما إن كان إسلامك بالكلام فقط فكلُّ إنسانٍ يستطيع أن يقول: أنا إمبراطور، ويستطيع أن يقول: أنا وزير، ولكن سيكون مهزأةً لكل من يراه ولكل من يسمعه.
قالوا: “وحسن اللِّقَاءِ”، إذا لقي العدو في المعركة يلقاه لقاء المجاهد الشجاع المحتسب دمه عند الله عزَّ وجلَّ، وإذا لقي عظائم الأمور يلقاها بلقاء الرجال أُولي العزم، فلا ينهار لشدةٍ أو أزمةٍ، وإذا لقي من له عليه حق يلقاه بأن يؤدي إليه حقه ويزيده على حقه.
فهل هذا من المغبونين؟ هؤلاء العرب في الجاهلية! والآن هل هذه أخلاق المسلمين؟ تراه وقد يكون عنده مكتبة، وقد يكون حائزًا على شهادة أو شهادات واسمه مثقَّفٌ، لكن هل يا ترى عنده الشكر عند الرخاء الذي كان موجودًا في الجاهلية؟ وهل عنده الصبر عند البلاء والرضى بمُرِّ القضاء؟ وهل عنده ترك الشماتة بالأعداء؟ وهل عنده حُسن اللقاء؟ فأقرَّهم النبي عليه الصلاة والسلام ، وكذلك يقول النبي ﷺ: ((جِئتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ)) ، فما كان موجودًا من المكارم أقرَّه وزادهم على ما نقص منهم.. فنسأل الله عزَّ وجلَّ أن يُكمِّل لنا إيماننا.. الحديث طويل، يكفيكم منه إلى هنا.
جزاء الصبر عند المصاب عظيم عند الله تعالى
﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله﴾ [التغابن:11] إذا فقدتَ ابنك أو مالك أو صحتك أو بصرك.. كان عليه الصلاة والسلام يقول: ((إذا فَقَدَ المؤمِنُ إحدَى كَرِيمَتَيه فَصَبَرَ وَاحتَسَبَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيدُ عَيْنَيْهِ)) ، معنى “احتسب” أن يقول: يا رب أنا صابر فاحسبها لي عندك رضًى بقضائك وقدرك، ولا تحرمني أجرها ولا ثوابها.. هذا العمل ما اسمه؟ هذا اسمه الاحتساب، وصاحبه محتسِب، وكذلك المرأة إذا فقدت زوجها أو طُلِّقت من زوجها: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله﴾ [التغابن:11]، ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ﴾ أي عِلْم الله عزَّ وجلَّ بهذه الأقدار مِن قبل أن تقع، وعِلْمه بها ﴿عَلَى الله يَسِيرٌ (22)﴾ وقد أخبرناكم، ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [الحديد:22-23] والمقصود من الفرح هنا البطر والفرح الذي يخرجك عن حدود الله عزَّ وجلَّ إلى معصيته.
فإذا أردنا أن نحاسب أنفسنا على مقتضى آية من آيات القرآن، فهناك أناس -ما شاء الله- عندهم الخير الكثير، ومَن كان منّا مقصِّرًا فليُشَمِّر ويجتهد قبل أن يأتيه الموت ويصير في خَانَة [وقِسْم] المغبونين، فيسأله الله عزَّ وجلَّ: هل قرأتَ سورة التغابن؟ فيقول: نعم قرأتُ، فيقول: ماذا فهمتَ؟ فيقول: لم أفهم شيئًا، فهذا ما قرأ، وهذا ﴿كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ [الجمعة:5].
قال: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِالله﴾ الإيمان بالله عزَّ وجلَّ هنا يعني الإيمان بقدر الله عند المصيبة، ﴿يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ [التغابن:11] يَهدِه إلى الرضى والاستسلام، بل والفرح بثواب الله عزَّ وجلَّ على ما أصابه.
أتت امرأةٌ إلى سيدنا رسول الله ﷺ، فشكَت له وقالت: “يا رسول الله إِنِّي أُصْرَعُ”، تصاب بالمرض الذي يُسمُّونه داء الساعة [الصَّرَع]، “فادعُ الله لي أن يشفيني”، سبحان الله! سبحان الله! “بذِكر الصالحين تنزل الرحمة” ، وهل هناك أصلح من تلامذة رسول الله ﷺ الذين تخرَّجوا في مدرسته وتخرَّجوا في تربيته ورعايته؟
فقال لها: ((إِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ لَكِ فَشَفاكِ، وإِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ فَدَخَلْتِ الْجَنَّةَ))، يعني بصبرك ورضاك بقضاء الله عزَّ وجلَّ وقدره.. فلو كنتم أنتم في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وأُصبتم بهذه الحالة والنبي ﷺ خيِّركم فماذا تختارون؟ من يختر الشفاء يرفع أصبعه، ومن يختر الجنة يرفع أصبعه، [بعد أن رفع الحضور أيديهم خاطبهم سماحة الشيخ:] هذا في الجامع، وكيف خارج الجامع؟ نسأل الله عزَّ وجلَّ أن يثبِّتنا بقوله الثابت.
فقالت: “يا رسول الله، ادع الله لي بالجنة”، أريد الجنة، وسأتحمل مرضي وصرعي وما يعقبه من أوجاع ومن كذا وكذا ومن محنٍ، “ولكن ادع الله لي إذا صُرعتُ أن لا أتكشَّف”، أي أن لا تظهر عورتها، فهي رضيَتْ بقضاء الله عزَّ وجلَّ مقابل الأجر والثواب الذي ثمرته الجنة.
أساتذة إيمان العمل خريجو المدرسة النبوية
هذه المرأة لا تَقرأ ولا تَكتب، وهل هذه أفضل أم خرِّيجة الجامعة؟ خريجة الجامعة اليوم لو شاكتها شوكة أو خدشتها هرة لصرخت وطار عقلها، ولا تستطيع أن تتحمل بعوضة، فأين الرجال؟ وأين المؤمنون؟ وأين المؤمنات؟ أتظنُّون الإيمان يحصل بالميراث، أو لأن أباك مؤمن تكون مؤمنًا؟ قد يكون أبوك جاهليًّا وجدك جاهليًّا وعائلتك جاهلية، فلا تكن ﴿مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾ [المائدة:41] هل نال الصحابة الإيمان وهم في مساكنهم وقراهم أم هاجروا إلى رسول الله ﷺ فتركوا المال والأهل والولد وتحمَّلوا من الإيذاء والمشقَّات أشكالًا وألوانًا؟ وهذه المرأة تُعَدُّ مِن العَادِيَّات العَادِيَّات، [امرأة عادِيَّة: استخدام عامّي، بمعنى امرأة من عامّة النساء والعوام ومثل كثير من النساء، وليست مُمَيَّزة عن غيرها] فكيف كان الذين هم في أعلى الدرجات؟ رضوان الله عليهم.
وأنتم “ما مَحَلُّكم من الإعراب” في الإيمان بـ ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ﴾ [التغابن:11]؟ [قوله: “ما مَحَلَّكم من الإعراب” استخدام في اللهجة العامية، وهو على شاكلة الإعراب في النحو، ويعني هنا: أين مكانكم في الإيمان وما هو حالكم فيه؟] فإذا فقدتَ ابنك أو بنتك أو زوجكِ أو زوجتكَ أو مالك أو سيارتك هل عندك الرضاء بقضاء الله عزَّ وجلَّ وقدره؟ هذا شيء وقع.. ولماذا أوجب الله عزَّ وجلَّ علينا الإيمان؟ هل من أجل أن يَلْبِس اللهُ عباءة من إيماننا؟ بل فرض عليك الإيمان لئلا تَزْعَل يا مسكين فتُصاب بجلطة، ولئلا تصاب بمرض السكر، ولئلا تُصاب بالفالج، وإن إبعاد الهم والحزن بحسب العلم والطب مما يطيل العمر، [سماحة الشيخ يسأل أحد الأطباء الحضور:] أليس كذلك دكتور؟ فنسأل الله عزَّ وجلَّ أن يرزقنا الإيمان بمعناه الحي الحقيقي، ويا ترى هل تستطيع أن تتكلَّم اللغة الإنكليزية من غير أستاذ اللغة الإنكليزية؟ فمن أستاذك في الإيمان؟ ومن أستاذك في الإسلام؟ الحدَّاد له أستاذ، والنجَّار له معلم، والفلاح له أستاذ، حتى الشحَّاد [المتسوِّل] له معلِّم.
قيل: مرة رأى جحا رحمة الله عليه فتاة جميلة بالطريق، فوقع بحبها، فقالوا له: أبوها شَحَّاد وهي شَحَّادة، فكيف تحبها؟ هذا مثل رجل أحبَّ امرأة سوداء، فقال له صاحبه: أما أحببْتَ إلا امرأة سوداء؟! فقال له
حَبَبتُ لِحُبِّهَا السُّودَانَ حَتَّى
حَبَبتُ لِحُبِّهَا سُودَ الكِلابِ
والحبُّ والعشق سلطانه لا يُقاوَم.. فأحب حجا هذه الشَّحَّادة [المُتَسَوِّلَة]، وذهب ليخطبها من أبيها، فقال له: لا أزوجكها، قال: لماذا؟ سأعطيك ما تريد، قال له: ولو بذلتَ جبلًا من الذهب، لأنَّك غدًا إن غضبتَ منها تقول لها: يا بنت الشحَّاد، فلو شحدتَ أربعين يومًا حتى تأخذ شهادة الشحَّادِين أُزوِّجُكَ إياها، حتى إذا عيَّرتَها بأبيها، تقول لك: وأنت أيضًا شحَّاد.
فذهب جحا وتعرَّف على أستاذ بالشِّحادَة [بالتسوُّل] كي يتعلَّم مهنته، لأنَّ العلم لا يُنال بلا معلِّم، وبعد أربعين يومًا قال له: قد أخذتُ الشهادة، فقال له: هيا بنا نذهب إلى “حَمّام السوق”، [حَمّام عامّ يغتسل فيه الرجال بالأجرة، وغالباً ما يكون في الأسواق أو قريباً منها، وقد كانت هذه الحمامات موجودة بكثرة في بلاد الشام وتركيا]، وبينما هم أمام جُرْن الحمام، [جُرْن الحمام: وعاء كبير، غالباً ما يكون مصنوعاً من الحَجَر، توضع فيه الماء الحارة للاستحمام] قال جحا لعمه أبي زوجته: يا عمِّي واللهِ لقد نسيتُ الصابون، فمن فضلك هل يمكن أن “تُشَحِّدْني” صابونتك، فقال له: الآن قد صرتَ شحَّادًا أَصْليًّا حقيقياً. [كلمة “تُشَحِّدْني” تُستَخدَم باللهجة السورية بمعنى التسول، وتُستخدَم إضافة إلى ذلك عند العوام غير المثقفين بمعنى: هل يمكن أن تُعِيْرَني أو تُعْطِيَني؟]
الحاجة إلى أساتذة الإيمان
فمن أستاذك بالإيمان؟ الإيمان بالله عزَّ وجلَّ أن تراه معك حيثما كنتَ، وإذا وقعتَ في معصية تجد الله عزَّ وجلَّ معك يراك ويسمعك، والملائكة تسجل عليك ما تعمل وما تقول.. هذا هو الإيمان.
أمَّا أن تدَّعي الإيمان فبالادِّعاء كل شيءٍ يمكن ادعاؤه، ولكن هل لذلك من حقيقة؟ نسأل الله عزَّ وجلَّ أن يرزقنا المعلم.. ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾ [البقرة:129] أين معلِّمك للكتاب؟ تَعَلُّم القرآن وكتاب الله عزَّ وجلَّ ليس أن تقرأه، بل أن تتعلَّمه حتى يدخل في أعماق وجودك، فيَنْعَكس ويَنْهَضم ويُمَثَّل فيك قرآنَ العمل والأخلاق والسلوك وخشية الله ومحبة الله والمسارعة إلى مرضاة الله عزَّ وجلَّ، وإلا فأنت مؤمن الأماني، ﴿تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (111) بَلَى﴾ الإيمان يكون ﴿مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ انقاد واستسلم لأوامر الله عزَّ وجلَّ واستجاب لها ﴿فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ يعني على أعماله، ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة:111-112].
﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِالله﴾ الإيمان الحقيقيَّ، ﴿يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ [التغابن:11] إلى الرضى بقضائه وقدره الذي ما وقع إلا على حسب النظام الكوني، وبأسبابٍ منك: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [النحل:118]، ﴿وَالله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [التغابن:11] يعلَمُ إيمانك عند المصيبة.. فهل رضيتَ بقضاء الله حتى يؤجرك على مصيبتك؟ مثل تلك المرأة المريضة بِداء الصرع لَمَّا علم الله عزَّ وجلَّ منها إيمانها ورضاءها بقضاء الله وقدره كافأها بماذا؟ بما بشرها به رسول الله ﷺ: ((أَو تَصبِرينَ وَأَدعُو اللهَ لَكِ بالجَنَّةِ؟)).
فغلب إيمانها بأنَّ الآخرة خيرٌ لها من الأولى، فَقَالَتْ: “بل أَصْبِرُ، وليَ الجنة، ولكن ادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ” فَدَعَا لَهَا، فكانت إذا صُرِعَت لا تتكشَّف .
طاعة الله تعني الرضى بما قضاه
﴿وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [التغابن:12] هنا الطاعة بأن ترضى بقضاء الله عزَّ وجلَّ، لأنَّ الطاعة عَقب أمرٍ من الأوامر تعني بشكلٍ خاص الإطاعة لذلك الأمر الإلهي.
إذا أحدكم -لا سمح الله- رأى بيته مسروقًا، أو ابنه ميتًا، أو هو صار معه شلل، أو خسر خسارة ذهبت بكل ماله، فعندها هل قرأت القرآن قراءة العلم؟ ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ [البقرة:121].
يذكرون عن عروة بن الزبير أنه أصابت الآَكِلَة رِجلَه فقُطِعَت، فدخل الناس عليه يعزُّونه فقال: “الحمد لله، ذهب مني عضوٌ وسلَّم الله لي بقية الأعضاء”، فما نظر إلى ما ذهب، بل نظر إلى ما بقي، ولما وصل إلى المدينة وقع ابنه في بئرٍ فمات، وهذه مصيبة ثانية، وقد جاءته تلوَ السابقة، فلما أُخبِر قال: “الحمد لله، عندي سبعة أولاد، ذهب واحدٌ وأبقى الله لي ستة” .. هذا هو الإيمان يا بني.
العلماء كالنجوم في هداية الطريق
الإيمان بالله عزَّ وجلَّ له مدرسته وثقافته وأستاذه ومعلِّمه ومُرَوِّضه ومربِّيه، والإيمان بالقرآن له معلِّمه وله مربِّيه وله مهذِّبه، فمَن أستاذك؟ إذا كنتَ محامٍ فلك خمسون أستاذًا في مدرسة الحقوق، وإذا كنتَ نجَّارًا فلكَ عدة أساتذة، فمن أستاذك في إسلامك؟ من ربَّاك؟ من زكَّاك؟ من علَّمك الحكمة حتى تنجح في كل أمورك، وتكون حياتك قائمة على العلم وعلى العقل الحكيم وعلى الأخلاق الفاضلة؟ هل يوجد إنسان يحمل هذه المعاني ولم يكن ناجحًا؟ لا يمكن.. ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم:47] والمسلمون الآن هل تعلَّموا كتاب الله عزَّ وجلَّ علمًا يُوجب العمل؟ وذلك على كل المستويات؟
ولعل البعض قد بدأ، ولكن لم يستكمل كلَّ الدروس حتى يتخرَّج في الجامعة، ولعله أخذ “السرتفيكا” وتوقَّف عندها، ولعله أخذ “الكَفَاءَة” وتوقف عندها، [السرتفيكا: الشهادة الابتدائية، وقد كانت في طفولة سماحة الشيخ في الصف الخامس، والكَفَاءَة: الشهادة الإعدادية، وهي الصف التاسع]، فيجب أن نُكمِلَ. [لعل بعض المسلمين تَعَلَّم شيئاً من الإسلام، ثم توقف ولم يكمله بكل فروعه، والإسلام كلٌّ لا يتجزأ، وعلينا أن نأخذه كما أتى به النبي ﷺ دون تجزيء].
والإيمان له أول وليس له آخر، لذلك كانت الهجرة فرضًا، ((لا إيمانَ لِمَنْ لا هِجْرَةَ لَهُ)) ، لأنَّ الهجرة كانت مدرسة العلم والحكمة وتزكية النفوس.
ففي زمن النبي عليه الصلاة والسلام هاجروا إلى النبي ﷺ، وبعد النبي هل انقطع العلم؟ وهل انقطعت الحكمة؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ)) ، العلماء بالله عزَّ وجلَّ، العلماء بثقافة القرآن، العلماء بالحكمة، العلماء بتزكية النفوس، الذين عندهم القدرة على أن يزكُّوا نفسك وينقلوها من الظلمات إلى النور، ومن حمقٍ وسفهٍ إلى حكمةٍ وعقلانيةٍ وصواب.
كما كان عليه الصلاة والسلام يقول: ((الْعُلَمَاءُ فِي الأَرْضِ كَالنُّجُومِ فِي السَّمَاءِ، فَإِذَا انْطَمَسَتِ النُّجُومُ يُوشِكُ الْهُدَاةُ أَنْ تَضِلَّ)) ، الدليل في الصحراء يراقب القطب الشمالي، فإذا تجمَّع الغيم وما ظهرت له الجهات الأربع بواسطة القطب الشمالي فسيتوه عن الطريق ويقع في الهلكة، ولذلك كان بعضهم يقول
أَمُرتَقِبَ النُّجُومِ مِنَ السَّماءْ
نُجُومُ الأَرضِ أَبهَرُ في الضِّياءْ
فَتِلْكَ تَبِينُ وَقتًا ثُمَّ تَخفَى
وَهَذي لا يُكَدِّرُها الخَفاءْ
هِدايَةُ تِلكَ في ظُلَمِ اللَّيالِي
هِدايَةُ هَذِهِ كَشْفُ الغِطاءْ
“فتلك”: التي في السماء.. “هداية تلك”: التي في السماء، “في ظلم الليالي”: في الليل تُبيِّن لك طريق بغداد وطريق مكة وطريق حلب.. “هِدايَةُ هَذِهِ كشف الغطاء”: تكشف غطاء الهوى والأنا عن عقلك، فتملؤه حكمةً ومعرفةً بالأسباب والمسبَّبات.. والإيمان يُعطيك الطاقة لترتبط بالأسباب والمسبَّبات في دينك وفي دنياك.
“هداية هذه كشف الغطاء”: يُكشَف الغطاء عن قلبك حتى تصل إلى مقام الإحسان، فتعبد الله كأنك تراه، ((كأني أَصْبَحْتُ بعَرْشِ رَبِّي بَارِزًا)) يعني كأني أنظر إلى الله في عرشه وعظمته، ((وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ في نَعِيمِهِم يَتَنَعَّمُونَ، وَفي جَهَنَّمَ يَتَعَذَّبُونَ))، فقال له عليه الصلاة والسلام: ((عَرَفْتَ فَالْزَمْ، عَبْدٌ نَوَّرَ اللهُ قَلبَهُ بِالإيمانِ)) ، هذه: ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ﴾ [ق:22].
فنسأل الله عزَّ وجلَّ أن يُوَفِّقَنَا إلى نجوم أهل الأرض، فإذا مشيتَ بالنور وصلتَ إلى المطلوب براحة وسرور، وإذا أردتَ أن تمشي في الظلمات فإنك ستقع في السقطات وفي المهاوي وفي الهلكة.. فنسأل الله أن يَرُدَّ المسلمين ويُهيِّئَ لهم من الهداة وأصحاب الأنوار ما يضيئون لهم طريق الحياة على حسب ما أوحى الله عزَّ وجلَّ به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام.
والصحابة والمسلمون عندما مشوا بنور رسول الله ﷺ وَصَلُوا في دنياهم إلى أبواب الصين، وبقوا في فرنسا مئة سنة، وكانت حدود العالَم العربي أو الدولة العربية -في لغة وقتنا- أو دولة الإسلام -في لغة القرآن- كانت نصف العالَم القديم موحَّدًا ثقافةً ووحدةً وسياسةً وجيشًا وكل شيء.
والآن العرب بالعروبة اثنتان وعشرون دولة، أما العرب بالإسلام فالله عزَّ وجلَّ ملَّكهم نصف العالَم، ولو استقاموا على الطريقة لصار العالَم كلُّه مسلمًا.. فنسأل الله عزَّ وجلَّ أن يُهيِّئَ الأسباب والوسائل، وهذا ليس بالدعاء، فكلُّ واحد منكم يجب أن يقوم ويعمل، وأن يعتبر نفسه هو المسؤول عن الإسلام، ليُوصِلَ ثقافة الإسلام وهدايته والسعادة به إلى مشارق الأرض ومغاربها، وكل واحد هكذا يجب أن تكون هِمَّته، وإن كان عمليًّا هذا لا يمكن، لكن أقل الدرجات حتى يكتب الله عزَّ وجلَّ له ما نوى، هل قال رسول الله ﷺ: “وإنما لكل امرئٍ ما عمل”؟ لا، ((وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى))، فالله يُؤجِر الإنسان المؤمن على نيته الصادقة المقرونة بالعزم سواءٌ تيسَّر له أن ينفِّذها أو استعصى عليه تنفيذها، فما دام أنه نوى بحزم وصدق، فـ ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))، هذا من حيث العمل، فإذا لم يتيسَّر العمل لعجزٍ، ((وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)) .
البلاغ على الرسول والطاعة على المبلَّغ
﴿وَأَطِيعُوا الله﴾ سواء الطاعة العامة بكل ما أوحى به، ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ بكل ما بلَّغ به، أو الطاعة في الحكم الذي اقترن بهذه الآية، وهو الرضى بقضاء الله وقدره، ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ أعرضتم ﴿فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [التغابن:12]، النبي ﷺ بلَّغ البلاغ الواضح الذي يُزيل كل الشُّبَه عن عقل المرتابين، فأزال كلّ الشُّبَه عقليًّا وبرهانيًّا ثم عمليًّا وواقعيًّا.
عندما كان عليه الصلاة والسلام في مكة ومَرِض أبو طالب أتى كفار قريش -وهذه من أخلاق الجاهلية- فقالوا: يا أبا طالب، أنت شيخنا ورئيسنا، ونخشى أن تموت ونحن ومحمدٌ كما تعلم، فيصيبه أذًى منا فتعيِّرنا العرب فيقولون: كانوا يُسالمونه من أجل عمِّه، فلما مات خَفَروا ذِمَّة عمِّه.. ما هذه الأخلاق والمروءة؟ هؤلاء وثنيون وهكذا أخلاقهم فكيف يجب أن نكون نحن؟ هل نراعي الشخص بعد موته إكرامًا له إذا كان له علينا حق؟ كما فعل الإمام الشافعي إذ أكرم ابن البدوي الأعرابي لأنَّ أباه الراعي قد علَّمه مسألةً من توافِه الأمور، هذا هو الإسلام، أما إسلام الركوع والسجود من غير أن تفهم وتَعِي ولا تنتهي ولا تأتمر فهذا إسلام الادِّعاء.
فدعا أبو طالب النبيَّ عليه الصلاة والسلام وقال لهم: تكلموا، فقالوا له ما أرادوا، ثم قال أبو طالب: يا ابن أخي هل سمعتَ قومك ما يقولون؟ قالوا: يكف عن آلهتنا، ولا يسب أصنامنا ولا يسب آباءنا.. لأنهم كانوا كفرة وإلخ، فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((أنا أُجيبُهم إلى ما يُريدُون إذا أَعطَوني كَلمةً واحدةً))، فقال أبو جهل: “وأبيك” يعني وحياة رأس أبيك، “لنعطينك كلمةً وعشرًا فوقها”، فقال لهم: ((أَعطُوني كَلمةً إذا قُلتُمُوها تَملِكُونَ العَرَبَ)) هنا الشاهد، ((وَتَدِينُ لَكُمُ العَجَمُ، وَيُؤَدُّونَ لَكُمُ الجِزيةَ))، تصيرون ملوك الأرض بكلمة واحدة، قال أبو جهل: وأبيك، نُعطيكها وعشر كلمات، قال: ((قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)) ، قالوا: لا، غير ذلك، فقال لهم: ((لَوْ وَضَعتُم الشَّمْسَ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرَ فِي شِمالِي عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الْأَمْرَ)) وتبليغ هذه الرسالة ((ما فَعلْتُ حتَّى تَنفَرِدَ منِّي هَذِهِ السَّالِفةُ)) ، صلى الله عليه وآله وأحبابه وأصحابه وسلم.
﴿وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ [التغابن:12] وأنتم هل تطيعون؟ كلمة “نعم نطيع” تعني أنكم كتبتم سَنَدًا على أنفسكم وأَمْضَيْتموه، [كتبتم سنداً: كما يكتب المستقرض للمال ورقة رسمية أو سَنَداً على نفسه، ثم يضع عليها إمضاءه أو ختمه]، والقرآن كله أوامر الله وكله وصايا الله، ويجب أن نقرأه بفهم للتطبيق وللعمل، ثم للتعليم بأقوالنا وأعمالنا وإخلاصنا وصدقنا واستقامتنا.
﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [التغابن:12] لأنَّ الله عزَّ وجلَّ قال: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء:80]، ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل:44] وكلام النبي عليه الصلاة والسلام شرح وتفسير وتوضيح للقرآن العظيم.
﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ أعرضتم ولم تُصغوا ولا استجبتم ولا امتثلتم، ﴿فإنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [المائدة:92] البلاغ الموضِّح المقنِع العقلاني البرهاني.
نتيجة التوكل على الله تعالى
﴿الله لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ هذه الأحكام وهذه التعليمات من الذي “لا إله إلا هو”، ﴿وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ﴾ وليثق ﴿الْمُؤْمِنُونَ﴾ [التغابن:13] ليثقوا بتعاليمه وبأوامره وبنواهيه وبأنه علَّمنا لنكون أسعد مخلوقات الله عزَّ وجلَّ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة:6¬-7].
فلما اتَّبَعوا أوامره ووثقوا بها كانوا ملوك الأرض وملوك السماء، وكانوا أعِزَّة في الحياة وبعد الممات، وكانوا غُرَّةً في جبين التاريخ لثقتهم ويقينهم بأوامر الله عزَّ وجلَّ.
وأنتم وإلى يوم القيامة إذا كنتم مؤمنين فتوكَّلوا وثِقُوا، فإذا وثقتَ بأن هذا شيكٌّ فيه مئة ألف ليرة أو مليون، وأعطاك إياه شخص، وأنت تعرفه أنه شيكٌّ فهل تتوقف عن القبض؟ ولكن إذا أعطاك جريدة عتيقة وقال لك: هذه فيها عشر ملايين، وأنت تراها جريدة عتيقة، هل تقبَل؟
والله عزَّ وجلَّ يعطينا هذه الهدية الإلهية السماوية: القرآن، وهو للعلم والعمل، وعبر التاريخ: بأيِّ شيءٍ نَصَرَ الله عزَّ وجلَّ صلاح الدين وهزم الغرب كله وهزم الصليبين كلهم؟ وكذلك الملك المظفر قطز الذي هزم الله على يده التتر كلهم بِـ﴿وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ﴾ فليثق ﴿الْمُؤْمِنُونَ﴾ [التغابن:13].
فكانوا مؤمنين بقلوبهم وأعمالهم وأفكارهم الحكيمة المستمَدَّة والمترشِّحة من كلام الله عزَّ وجلَّ وهدي رسول الله ﷺ، فنسأل الله عزَّ وجلَّ أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يردَّنا والمسلمين جميعًا إلى صراط الله ردًّا جميلًا.
العودة إلى الله هي الحل لمشاكلنا
نحن بحاجة إلى رجعة إلى الله، ونقلة من الجهل إلى العلم، ومن الأهواء ومن الهوى إلى التقوى، وهذه لا تكون بلا معلمٍ ولا مربٍّ، وليس هناك صنعة تتعلَّمها -حتى “الشِّحادَة” [التَسَوُّل] كالقصة التي ذكرتُها قبل قليل- إلا بأستاذ.
والمسلمون الآن بالنسبة لجوامعنا هل هي مملوءة بالعلم والحكمة والتزكية؟ هل فيها المعلِّم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان في مسجده الشريف ليل نهار وصباح مساء: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ [السجدة:16] هذه مادة الإيمان التي هي حَقْن الروح بالعبادة والخشوع والذكر الدائم.
فكل واحد منكم يجب أن يعتبر نفسه هو المسؤول عن الإسلام، ويعمل وفق: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:16]، فيُصلِح أهله ويبذل الجهد، وليس شرطًا أنَّ يستجيب الناس له، فقد يستجيب البعض ويرفض البعض، وهل كل الناس استجابوا للنبي ﷺ؟ وهل استجابوا له من أول يوم؟ بل رجموه بالأحجار، وشيَّعوا عليه الشائعات، وكَذَبوا عليه الأكاذيب، وآذوه بكل أنواع الإيذاء.
وهكذا كل من يقوم بالدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ، فشياطين الإنس ألعن أنواع الشياطين، فقد يأتي بصورة أخيك أو ابنك أو زوجتك، ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ﴾ [التغابن:14] أو رفيقك، فيقول لك: هل ستذهب إلى الدرس؟ ألا زلتَ رَجْعِيًّا؟ أنت مثقف، [انتشرت في المجتمع السوري في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين بقوةٍ كلماتٌ تحارب الدِّين وأهله، مثل قولهم: رجعي ومُتَخَلِّف، يصفون بها المشايخ وطلبة العلم الشرعي وكل مظهر من مظاهر الدين، حتى من يصلي أو يذهب للمسجد أو له لحية كان يقال عنه ذلك، وكان المعاكس لهاتين الكلمتين: مُثَقَّف ومُتَقَدِّم.. ولا ريب أن هذا كان من آثار المدِّ الشيوعي والتوجه الغربي المعادي للدين].. علينا أن نقوم وأن نُوطِّن أنفسنا أنَّ الطريق ليس مفروشًا بالورود، ولكن الإيمان يجعل من الأشواكِ ورودًا، ويجعل من المشاقِّ سهولةً، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق:4] خاصةً في هذا الوقت الذي ظهر فيه حديث النبي ﷺ بشكلٍ عملي حيث يقول: ((تَدَاعَى عَلَيْكُمُ الْأُمَمُ)) هذه هيئة الأمم، ((كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا)) ، هيئة الأمم من أجل الكويت قامت قيامتهم، وهل هذا من أجل الكويتين؟ لا، بل من أجل البترول، وليقيموا لهم مركزًا استعماريًّا دائمًا وقائمًا، وفي الصومال أيضًا ظهر البترول، وقد رأيت في مجلة عن الصومال تحت عنوان: “اطلبوا النفط ولو في الصومال”، هل هم هناك من أجل الصوماليين؟
في البوسنة والهرسك ليس هناك بترول، فسجَّلوا على أوروبا في القرن العشرين أقذر وسام وحشي متجرِّد عن كل إنسانية وعن كل أخلاق وعن كل القوانين، والمسلمون يناديهم الله عزَّ وجلَّ: إليَّ إليَّ! إلى كتابي! إلى مَرْكَبي! إلى القرآن! ونحن نقرؤه بشرط أن لا نفهم، ونسمعه لأجل الغناء لا لأجل المعاني.. وإلى متى؟
الدعوة إلى الوحدة ونبذ أسباب الفرقة
كما أنَّ أعداء الإسلام يُفرِّقُون بين المسلمين بكل الوسائل المتاحة، وفي كل الميادين، فيستعملون السياسة والاقتصاد والدعاية والإذاعات والإعلام، ويبثُّون الفتن بين المسلمين.. وما أحرى وما أفرض وما أوجب على المسلمين في هذا الوقت أن يكونوا أمةً واحدة.
﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ [الأنفال:24]، لذلك يجب على المسلمين أن يكونوا كلمةً واحدة، وأمةً واحدة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ((كالْجَسَدِ الواحدِ)) .
إنّ الاستعمار والصهيونية وجنودهما يزرعون الفتن ويزرعون الفساد في الأرض، وهذا من أول تاريخ الإسلام، فاليهود فعلوا ما فعلوا وأوجدوا من الفتن ما هو مسجَّلٌ في التاريخ، لذلك في هذا الوقت يجب على المسلمين أن ينظروا إلى بعضهم على أنهم أمة واحدة، وعائلة واحدة، وشخصية واحدة، لا سني وشيعي، بل كل مسلمٍ هو من شيعة أهل بيت رسول الله ﷺ، فهل منكم من لا يتشيَّع لسيدنا علي والسيدة فاطمة رضي الله عنهما فليرفع أصبعه؟ والمتشيِّع هو من تشيَّع لرسول الله ﷺ وأهل بيته، ومن هم أهل بيته؟ سيدنا علي رضي الله عنه من أهل بيته، وبنو هاشم كلهم من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من حَرُمت عليهم الزكاة يُعتَبَرون من آل بيت رسول الله ﷺ يعني من أهل بيته، وأزواجه رضي الله عنهنَّ من أهل بيته، والسيدة فاطمة رضي الله عنها من أهل بيته، وذرية فاطمة وعلي رضي الله عنهما وإلى يوم القيامة من آل بيته.
فنحن نُحِبُّ أهل بيته، ونحبُّ عليًّا وفاطمة رضي الله عنهما، وكل من يُحِبُّ عليًّا وفاطمة، وكل من يناصر عليًّا وفاطمة رضي الله عنهما، وكرَّم الله وجوههما، وحشرنا الله معهما في الدار الآخرة تحت لواء سيد المرسلين، ومن قاتل مع سيدنا علي رضي الله عنه في الجمل أو في غير الجمل هؤلاء مؤمنون ومسلمون، ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات:10].
ويوجد في هذا الوقت مِن أعداء الإسلام ومن أعداء العروبة ومن أعداء الوطن من يَدُسُّون الدسائس ويُشِيعون الإشاعات بالإفك والزور والبهتان ما يَرُوج على ضعفاء العقول وبسطاء الأفكار، فأين إسلام قول الله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات:6]؟ فكيف إذا كان الذي أتى بالخبر ليس مجرَّد فاسقٍ بل هو ملحد وعدوٌّ لله، وعدوٌّ لسيدنا محمد ﷺ فهل نصدِّقه مباشرة؟! أين القرآن؟ هل أنت مسلم؟ هل أنت مؤمن بالقرآن؟ هل قرأتَ القرآن؟ هل قرأت: ﴿فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (8) وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ [القلم:8-9]؟ هل قرأتَها؟ هل آمنتَ بها إيمان العمل أم إيمان اللفظ بلا عمل وبلا فهم وبلا تطبيق؟ ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ﴾ [القلم:10-13].
فإذا بلغك عن أخيك المؤمن كلمة فلا تقبلها مباشرة، وإلا فتكون قد خرجتَ عن القرآن، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ قال: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ﴾ [القلم:10-11] والنمام يكون صادقًا فيما يقول، وهو ينقل الخبر الواقعي العملي لأجل الإفساد والتفريق بين المتحابِّين وبين المؤمنين، وهو صادقٌ في نقل الخبر، أما إذا كان كذَّابًا فهذا اسمه أفَّاك، واسمه كذَّاب، وأول الآية: ﴿فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ﴾ [القلم:8] المكذبين عمومًا في الأخبار وفي غيرها، ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ﴾ [القلم:10] ولو أَتبَع خَبَرَه باليمين، ولم يقل: “حالف”، بل قال: “حلَّاف” بصيغة المبالغة، فقد حلف يمينًا ثانيًا وثالثًا ورابعًا، لأنه ﴿هَمَّازٍ﴾ مغتاب ﴿مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ﴾ [القلم:11-12] فكيف إذا كان مهدِّمًا للخير ومهدِّمًا للمحبة والصحبة بين المتحابِّين أو بين المؤمنين؟ نسأل الله عزَّ وجلَّ أن يرزقنا الإيمان.. والإيمان هو الدرع الواقي من سهام الأعداء ومن سهام الشيطان، ونسأل الله أن يُثَبِّتَنَا بقوله الثابت، وأن يجمع كلمة المسلمين على كتاب الله عزَّ وجلَّ وسنَّة رسول الله ﷺ.